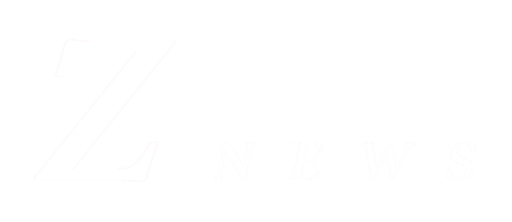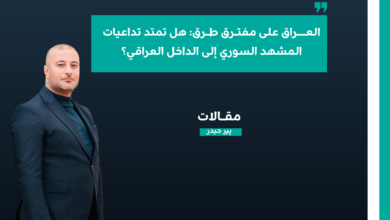فرمان سنة 1837 بحق الإيزيديين في جبل شنكال: دراسة تاريخية في سياق الصراع العثماني – الإيزيدي
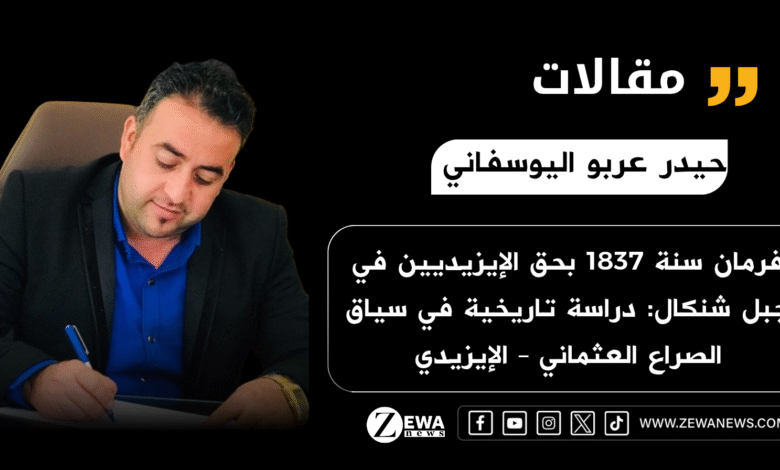
مقالات / حيدر عربو اليوسفاني
مقدمة
تُعد الفرمانات التي تعرض لها الإيزيديون في العهد العثماني من أكثر الأحداث دمويةً في تاريخ الأقليات الدينية في الشرق الأوسط. وفي مقدمتها فرمان سنة 1837 الذي استهدف سكان جبل شنكال، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لسياسة الإبادة والاضطهاد التي مارستها الدولة العثمانية ضد الإيزيديين. يستعرض هذا البحث السياق التاريخي والسياسي والعسكري للفرمان، ويحلل أسبابه وتبعاته من منظور تاريخي نقدي.
أولاً: الخلفية التاريخية للعلاقة بين الإيزيديين والدولة العثمانية
تنتمي الديانة الإيزيدية إلى الأديان القديمة ذات الجذور العميقة في شمال بلاد الرافدين. وقد واجهت هذه الأقلية الدينية اضطهادًا ممنهجًا في عهود متعددة، لا سيما خلال الحقبة العثمانية، إذ اعتُبرت ديانة “غير سماوية” بحسب التصنيف الفقهي للدولة، مما أتاح إصدار عشرات الفرمانات لإبادتهم أو إخضاعهم.
وقد تدهورت العلاقة بين الإيزيديين والدولة العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، خصوصًا بعد مجازر محمد باشا الراوندوزي عام 1831 في منطقة الشيخان، والتي راح ضحيتها آلاف الإيزيديين، وتم فيها تدنيس معابدهم في لالش، مما أثار حالة من الغضب والاحتقان بين العشائر الإيزيدية.
ثانيًا: حادثة القافلة العثمانية وبداية الصدام المباشر (1836)
في أبريل 1836، هاجمت مجموعة من المقاتلين الإيزيديين قافلة عسكرية عثمانية كانت تقل رواتب وعتادًا من الموصل إلى شنكال. وقد خططت العشائر الثلاث: بيت الخالد (مالا خالتى)، والمهركان، والبكران، لهذا الهجوم كعمل انتقامي مباشر لجرائم 1831.
أسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود عثمانيين، واستسلام 27 آخرين، إضافة إلى الاستيلاء على الذهب والعتاد. وبالرغم من أن الهجوم كان ذا طابع انتقامي، إلا أنه عُدَّ من قبل الدولة العثمانية تمردًا خطيرًا يستوجب الرد العسكري الحاسم.
ثالثًا: فرمان 1837 ومخطط الإبادة العثمانية
بعد وصول الأسرى إلى ماردين وتقديمهم تقريرًا عن الحادث، أصدر السلطان عبد المجيد الأول فرمانًا بتجهيز حملة عسكرية ضخمة بقيادة حافظ باشا لإخضاع الإيزيديين وإبادتهم، وذلك بموافقة المجلس العسكري العثماني المكوَّن من سبعة باشوات.
نُفّذ الهجوم عبر تطويق جبل شنكال من أربعة محاور، وتعرضت قرى المنطقة للحرق والنهب، وارتُكبت مجازر مروعة بحق المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، حتى أن الكهوف التي احتمى بها السكان قصفت بالقنابل الخانقة.
رابعًا: المقاومة الإيزيدية وتكتيكات الصمود
رغم المرض والمجاعة، تمكن المقاتلون الإيزيديون من تنظيم مقاومة بطولية، خصوصًا عند موقع البكران شرق الجبل، حيث تحصن نحو 150 مقاتلًا خلف ساتر قديم من بناء كلداني. فشل العثمانيون في اقتحام الساتر رغم خمس محاولات متتالية، وخسروا أكثر من 350 جنديًا.
كما نفّذ الإيزيديون هجمات ليلية جريئة داخل معسكرات العثمانيين متنكرين بملابسهم، ما أدى إلى قتل العديد من الجنود وسرقة الأسلحة والمؤن. مما دفع القادة العثمانيين لإعادة النظر في جدوى استمرار المعركة.
خامسًا: نتائج الحملة العسكرية وتداعيات الفرمان
أمام الخسائر الفادحة، وافق حافظ باشا على الانسحاب من جبل شنكال بعد فشل الحملة، وأرسل 180 أسيرًا إيزيديًا إلى إسطنبول كدليل على “إتمام المهمة”، في حين أن عددًا كبيرًا من السكان قد قتل أو نزح، وتم تدمير مناطق واسعة من الجبل.
مثّل هذا الفرمان مرحلة فارقة في التاريخ الإيزيدي، إذ عزز من الوعي الجمعي بالمظلومية التاريخية، وأسّس لفكرة المقاومة الوجودية ضد أي محاولة لإخضاعهم أو تذويب هويتهم.
الخاتمة
إن فرمان سنة 1837 ليس مجرد حدث تاريخي منعزل، بل هو حلقة في سلسلة من السياسات العثمانية التي هدفت إلى تدمير البنية الدينية والثقافية للإيزيديين. غير أن مقاومة جبل شنكال أثبتت أن الإبادة لم تكن قدرًا محتومًا، بل كانت دومًا تُقابل بصمود وإصرار على البقاء.
ويدعو هذا الحدث المؤرخين والباحثين إلى إعادة قراءة التاريخ العثماني من منظور الأقليات المهمشة، والتفكير في كيفية توثيق وإحياء ذاكرتهم التاريخية التي لا تزال تعاني من التهميش والنسيان.